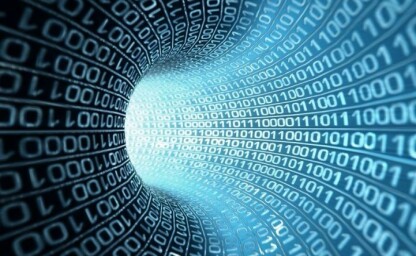أصل الإشكالية
تظهر هذه العبارة حينًا وتخفت في حينٍ آخر بحسب حالة النفور المجتمعية من العلمانية، فإذا ارتفعت حدة النفور في مجتمعٍ معين لانتشار الوعي بحقيقة الفكرة العلمانية وما فيها من رفض للدين وعداء له، انسحبت هذه العبارة من المشهد وضعف تداولها، فإذا خفت حدة النفور المجتمعي طفت هذه المقولة إلى السطح.
وانسحابها من فضاء التداول العام بسبب تدين المجتمع ورفضه لها لا يعني انعدام حضورها بالكلية في هذا الفضاء لكن هذه المقولة تتفتت لتظهر في صورة مقولات أخرى تحمل ذات الدلالة، ولكن بعبارات مواربة، وأقل مكاشفة، تسعى لتقديم مفاهيم العلمانية كطوق نجاة للمجتمعات المسلمة وإن لم تنص صراحة على لفظة العلمانية.
وإذا فحصنا بدقة هذه المقولة وتساءلنا: العلمانية حل لأي شيء؟ فبالإمكان أن نستخرج عدة إجابات تشكل كل إجابة مقولة خاصة تحتاج إلى معالجة:
المقولة الأولى: العلمانية حل للخلاص من الاستبداد والطغيان.
ما من شك أن النفوس السوية تبغض الاستبداد والطغيان، فمن الذي يريد أن يعيش في ظل الاستبداد والطغيان والفساد؟ فهذا أمر فطري يتفق الجميع عليه، والكل ينشد مجتمعًا تسوده العدالة وحفظ الحقوق والحريات، ولا يقع فيه ظلم أو طغيان أو تعد. وهكذا تأتي هذه المقولة هنا لتلعب على وتر هذه العاطفة الجياشة في محبة الحقوق والعدالة والحرية سعيًا لتمرير فكرة العلمانية، فهي بحسب هذه الدعوى الحل والطريق الموصل إلى هذه الجنة المنشودة.
لكن السؤال الصعب والذي يستدعي جوابًا: ما علاقة العلمانية في التخلص من هذا النظام الاستبدادي الطغياني؟
وهنا ينكشف إشكال هذا الاختزال والتسطيح، وتأتي الإجابات المتعثرة التي لا تستند إلى جواب علمي موضوعي صحيح، لتضعف قيمة هذه المقولة بالكامل، فالعدالة والحرية والكرامة لا تتحقق بمجرد رفع شعاراتٍ وتنميق كلماتٍ، بل هي تتطلب نظامًا متكاملًا وثقافة عامة ومؤسسات قوية. وهذا يتجاوز بسنوات ضوئية التفكير الساذج بأن العلمانية هي الحل أو ليست هي الحل، فالحقيقة أن هذا من قبيل الترف الفكري الذي يبتعد عن البحث في الأسباب الحقيقية لعلاج المشكلة إلى فتح مشكلة جديدة لا علاقة لها بأي علاج!
سيقال هنا: وماذا عن النظام العلماني في العالم الغربي الذي قدم نموذجًا قويًا لحفظ الحقوق والحريات لأوطانهم؟
والجواب بعيدًا عن مناقشة تفاصيل ما يندرج في مفهوم الحرية وحفظ الحقوق، وهل هي مقبولة في التصور الشرعي أم لا. نجاح تجربةٍ علمانيةٍ معينة في مكان أو زمان معين لا يعني أن العلمانية هي الحل السحري للنجاح في كل زمان ومكان، فالعلمانية في الثقافة الغربية مرتبطة بتجربة تاريخية طويلة مليئة بالعلاقات المتشابكة بين عقائدهم الدينية وحكوماتهم الدنيوية، وتمخضت هذه التجربة المرهقة إلى هذا الخيار، فأنشأوا بناءً عليه مؤسساتهم، وشكلوا أنظمتهم، وعززوا ثقافتهم، فهو خيار له خصوصيته، ونجاح العلمانية في سياق معين في تحقيق بعض مظاهر العدل والحرية لا يعني أنها ستنجح في كل سياق، وكما وجدت أنظمة علمانية لديها قدر عالٍ من المحافظة على الحقوق والحريات، فلقد وجد في المقابل من الأنظمة العلمانية من سحق الإنسان، ودمر المجتمعات، وأنهك الحقوق، فالتفكير في حفظ الحقوق من بوابة العلمانية سذاجة في الوعي الفكري والتاريخي.
وبناءً على ذلك، فاستنساخ هذا الخيار وتعميمه على جميع الناس هو من قبيل الكسل الفكري الذي يتعطل فيه عقل الإنسان فلا يكاد يفكر بغير منظار الآخرين، بل هو يعبر عن انكسار نفسي تتهشم فيها المناعة الذاتية للشخص فلا يظن أن هناك طريقًا للنهوض إلا بتقليد خطى الآخرين.
فإذا ما فككنا بُنى العلمانية ونظرنا فيها، وفيما ولدته في الواقع من مظاهر أودت بنزع القداسة عن كل شيء، وأفضت إلى سلخ مختلف الجوانب الحياتية من القيم والأخلاق، وأدت إلى تسليع الإنسان وجعله مجرد أداة استهلاكية، وغير ذلك من مشكلات، علمنا مدى سذاجة التعلق بمثل هذه الشعارات لتقديم حلولٍ لتعقيدات الواقع.
إذن، الخلاص من الاستبداد والطغيان، والبحث عن الحقوق والحريات دافع مهم ومحفز ضروري، لكن توهم أن العلمانية هي الحل وهم كبير، وهي مجرد حالة نفسية تسكن المتأثرين بالعلمانية لأنهم يرغبون في العلمانية!
المقولة الثانية: العلمانية حل للخلافات العقدية والدينية.
وهنا يأتي الحديث عن الخلافات العقدية الكبرى بين الناس، فيسترسل صاحب هذه المقولة متحدثًا عن حجم الاختلافات بين الأديان، وشارحًا طبيعة الاختلافات الواقعة داخل كل دين، وحاكيًا ما في الواقع من مذاهب متناحرة، وما يقع بينها من تكفير وقتال واحتراب، وكله بسبب الاختلاف في الدين والمعتقد، وهو ما يمكن تلمسه من خلال التاريخ وفي معطيات الواقع، فالحل هو في العلمانية التي تُحيّد هذه الأفكار جميعًا فلا يكون لها أي أثر سلبي في واقع الناس وتفاعلهم مع بعضهم.
ولا شك أن الاختلاف في الدين والعقائد أحد مسببات وقوع الخصومات الشديدة بين الناس، وقد يقع بسببها مظالم وانتهاكات حقيقية، وقد ارتضت الثقافة الغربية أن تأخذ العلمانية مسلكًا لحل هذه الخلافات، نظرًا لطبيعة التجربة التاريخية للدين عندهم حيث ضعف مفهوم الدين، وكثرت الخصومات فيه، وجرى تحريفه، فكان لا بد من نظام آخر بديل.
المشكلة هي في تعدية هذه التجربة إلى التاريخ الإسلامي، فهي تعدية تعبر عن غلط كبير، وقصور فاضح في إدراك حجم الفروقات بين سياق حضاري معين وسياق حضاري آخر مباين له، فالهيمنة في التاريخ الإسلامي كانت لحكم الشريعة طيلة ثلاثة عشر قرنًا، تعاقبت فيها دول في أمصار مختلفة وأزمنة متباينة، ولم يفكر أحد طيلة هذه القرون أن المشكلة في الدين نفسه، وإنما أرجعت أسباب الظلم والخصومات لأمور أخرى، أما الدين فكان محل اتفاق بين الجميع وإن اختلفوا في بعض تطبيقاته وأحكامه، فالحقيقة أن العودة إلى الدين هي الضمان للحقوق وللفصل بين الخصومات ولقطع النزاعات، وأما إلغاؤه فسيفتح المزيد من الخصومات.
فالإسلام هو الدين الضامن لإقامة العدل بين الناس، فالمُطَالب بمحاصرته بالفكرة العلمانية، وإلغاء سلطانه في الفضاء العام، أو المجال السياسي هو في الحقيقة قائلٌ بلسان الحال والمقال أن الإسلام ليس هو الدين الحق، وأن تحكيمه وتطبيقه لا يمثل الهداية المرجوة للبشر، وأنه لا يشتمل على ضمانات العدل المطلوبة، ولن نعجب من جريان مثل هذا الكلام على لسان كافر بهذا الدين، فهذا أمر متصور وهو يوجب مباحثة هذا الكافر في صحة دين الإسلام وبيان ما يشتمل عليه من محاسن وفضائل، إنما العجب من مُسْلمٍ يعتقد صحة هذا الدين ثم يستبطن مثل هذا التقرير، حيث إن الاعتراف بصحة الإسلام وأنه من عند الله يوجب على صاحبه أن يعتقد أن تمام الهداية والعدل لا تكون إلا في تحقيقه وتحكيمه.
إن حقيقة هذه الدعوى تقوم على فكرة ساذجة، هي أنه وبسبب وجود خلافٍ بين المسلمين في بعض جزئيات الحكم الإسلامي، فالحل هو في إبعاد الإسلام عنكم بالكلية، وفرض نظام مخالف لدينكم، لا ترضون به، ولا تعتقدون صحته، فتكرهون عليه بالقوة، لأنه هو الحل.
والحقيقة أن هذا لا يتضمن أي حل صحيح، ففرض قوانين العلمانية على الناس بالحديد والنار، وتحييد الشريعة بالقوة، لا يعني أنك قدمت حلًا، وإنما حكمت الناس بالقوة، والقوة يمكن أن تحكم بالعلمانية أو بأي نظام آخر، ولا يعني هذا أنها قدمت الحل، فحقيقة الحل العلماني هو دعم التغيير القسري والإبعاد الجبري لحكم الشريعة، ثم إقناع الناس بعد ذلك أن هذا هو الحل، لأنكم -بسبب سلطة القوة- لا تملكون حلًا غيره، وأي حل آخر فهو مرفوض بمنطق القوة لا بقوة المنطق!
وثم معنى مركزي يجب أن يكون حاضرًا في ذهن القارئ هنا، وهو أن النظم السياسية لا تنشأ في الواقع بناءً على اقتناع جميع الناس بها، فيتشكل النظام بطريقة تكون مقنعة للجميع، فهذا تصور مثالي لا وجود له في واقع البشر، فالنظم تفرض نفسها ثم تجتهد في إقناع الناس بعدالة قضيتها وحسن نظامها، وهي مدركة أنها مهما بلغت غاية الكمال في الإقناع وفي تحقيق العدل فإن ثم شريحة من الناس لن تكون راضية عن هذا النظام، لكن هذا لن يحول دون قيام النظام.
نقول هذا لنقرر أننا حين نقرر مشروعية حاكمية الشريعة فإننا ندرك أنه لا يمكن إقناع جميع من سيُحكم بالإسلام بهذا النظام، خاصة حين يكون غير مؤمن به، فليس بخافٍ أن غير المسلم يفضل أن يُحكم بدينه، لكن هذا المعنى لا يصح أن يكون سببًا لأن نلغي حكم الإسلام الذي نؤمن به، ونحرم المسلمين من الخضوع لشريعة ربهم، ونعطل بلدانهم من النظام الذي كان يحكمهم طيلة قرون، لا يمكن أن نلغي هذا كله لمجرد البحث عن إقناع جميع الناس بهذا الخيار، فهذا لا يمكن أن يتحقق، فهو لم يتحقق لأي نظام ولن يتحقق، وإنما الواجب أن يكون البرهان جليًا على أن هذا النظام سيضمن العدل للجميع، لا أن يقتنع الجميع بأنه أحسن لهم من غيره.
وهذه سمة كل نظام، فالنظام الليبرالي يعرف أن ثم شرائح متباينة ترفض هذا الخيار، لكنه لم يتوقف عن الاقتناع بأحقيته في الحكم، ولم يذهب للبحث عن خيارات جديدة بديلة عنه تكون أفضل لجميع الناس، وإنما يسعى من خلال التطبيق أن يثبت أنه هو الخيار الأفضل.
إذا استحضرت هذا أدركت سذاجة التفكير بجلب العلمانية لأجل وجود فئة معينة من الناس لن ترضى بحكم الشريعة، والظريف هنا أن إرضاء هذه الفئة القليلة يستلزم فرض نظام لا يقبل به الأكثر!
المقولة الثالثة: العلمانية حل لفهم أفضل للدين.
فالعلمانية في نظر صاحب هذه المقولة لا تحمل في طياتها عداءً للدين، ولا تحمل أي مخالفة له، بل هي تقدم العلمانية كسبيل أمثل لفهم صحيح وعقلاني للدين في مقابل الأفهام الضيفة والتفسيرات المتشددة له.
فالعلمانية تعيد الدين إلى وضعه الطبيعي في كونه علاقة بين العبد وربه، علاقة روحانية صادقة لا يحكمها أي قيد خارجي أو إكراه، فهذا المفهوم العلماني للدين هو في نظرهم المفهوم الصحيح للدين.
وهو في الحقيقة فهمٌ للدين في ضوء معيار أجنبي عنه، وليس فهمًا للدين كما هو في نفسه، فالعلماني لا يفهم الدين وفق مبادئ الدين وأصوله وأحكامه، وإنما يفرض أصول العلمانية على الدين، فيكون الدين مقيدًا بحسب المرجعية العلمانية وأدوات الفهم المتعلقة بها، وبطلا مثل هذا الكلام لا يتطلب الكثير من النقاش ممن عرف حقيقة الدين وطبيعته، إذ كل مسلم يعرف خطأ هذه الرؤية للدين بداهة، فالإسلام الذي يدينون به، وكتاب ربهم الذي يقرؤونه كل يوم، وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم التي يعرفونها مخالفة تمامًا لهذه الصورة، فلا يمكن لمسلمٍ صحيح الإيمان أن يقبل مثل هذا الكلام ولا أن يصدقه، فهو يدرك أن الإسلام ليس مجرد علاقة محدودة في دائرة ضيقة يتصل فيها العبد بربه، فهذه العلاقة جزء من الدين لكنها ليست الدين كله، كما أنه يدرك أيضًا أن الإسلام ليس مقيدًا بحدود معينة لا تتجاوز الحرية الفردية للشخص في مقابل حريات مضادة لغيره، بل هو يتمدد في الواقع بما هو أوسع من هذا ليكون هو الحاكم المهيمن في حياة الناس في مختلف التفاصيل.
إذن، الفهم الصحيح للدين عند العلمانية، هو أنهم يأخذون الدين ويفسرونه وفق الحدود العلمانية بلا نظرٍ في الدين ولا نصوصه ولا أصوله ولا تطبيقاته ولا أي شيء آخر، ثم علينا بعد ذلك أن نقبل منهم هذا التفسير ونشكرهم عليه ونقلدهم فيه لأن هذا هو منطق العقل وحرية التفكير!
المقولة الرابعة: العلمانية حل لعدم توظيف الدين في الخصومات السياسية.
وتحت هذه المقولة تحشد القصص والأخبار -الصحيحة والمكذوبة- لبيان صور توظيف الدين في السياسة، سواءً في هذا العصر أو في التاريخ الإسلامي المتقدم، أو في تواريخ الثقافات والشعوب الأخرى، لتلعب على وتر العاطفة النافرة من توظيف الدين لتقبل بالعلمانية.
وحين يُحيّد العاقل عاطفته ويفكر في هذه المقولة بشكل موضوعي صحيح، فإن واقع التوظيفات السياسية للدين لا تفضي إلى مثل هذه النتيجة العلمانية الغريبة بوجوب تعطيل الدين من الفضاء السياسي، إذ كل المعاني الجميلة وغير الجميلة يمكن أن توظف، فالحرية والديمقراطية والإنسانية والحقوق والأمن والعدل والوطنية والقومية وغيرها، كلُّها وظِّفت سياسيًا، وارتكب باسمها جرائم وفظاعات كثيرة، وجرى انتهاك عظيم لحقوق الإنسان ممن كان يتمسح بها، فلماذا لا يطالب بإلغائها جميعًا حتى لا توظف!
لا أحد يقول هذا، الدين فقط هو الذي يمارس معه هذه الطريقة الهزيلة في التفكير، بأن وجود من يستغل الدين يعني أن نلغي الدين، وكأن الواجب أن يكون حكم الدين حكمًا من عند رب العالمين لا سهو فيه ولا خطأ ولا ظلم مثقال ذرة أو نلغي حكم الدين من الوجود بالكلية، ولا شك أن هذا تفكير موغل في التطرف.
من يريد تصحيح هذا الشأن فالحل هو في وضع الضمانات التي تحول دون توظيف الدين خطأ، أو استغلاله في ارتكاب ما يخالفه، هذه الضمانات من مؤسسات وأدوات وثقافة عميقة هي التي يجب تستحدث في الواقع وأن تعمق في وعي الناس وحسهم لتمنع أي شخص أو جماعة أو نظام من استغلال الدين لتوظيف انحرافاته، وأما إلغاء الدين بالكلية لمنع الاستغلال فهو غلط في التفكير. وهو في نفس الوقت خيار غير عملي، لأن الناس لن يتركوا الدين لمجرد أنك قد تركته، بل سيبقى من يطالب بتطبيق الدين بصدق، ومن يريد توظيفه بالباطل كذلك، ولن يكون لمثل هذه الطريقة أي ثمرة عملية سوى العبث بدين صاحبها ورميه في أتون الشبهات.
إذن، فالعلمانية ليست حلًا لشيء، بل هي استنساخ بليد لمشكلة ثقافية في التاريخ الغربي، ولطبيعة علاقاتهم مع دينهم المحرف، جرى نقلها بكسل فكري إلى عالمنا الإسلامي، لتفسد تصورات الناس بلا ثمرة حقيقة في حفظ حقوق الناس، ولا تطبيق العدل بينهم، بل هي في الحقيقة أكبر عائق أمام أي دعوة حقيقية للعدل والحقوق.
المصدر:
عبد الله بن صالح العجيري وفهد بن صالح العجلان، زخرف القول: معالجة لأبرز المقولات المؤسسة للانحراف الفكري المعاصر